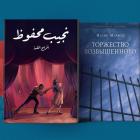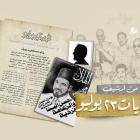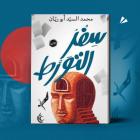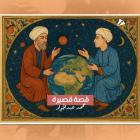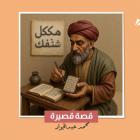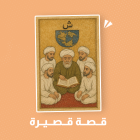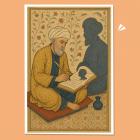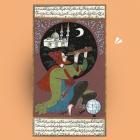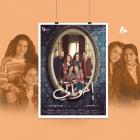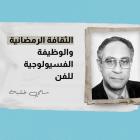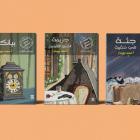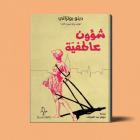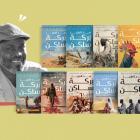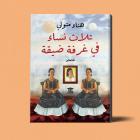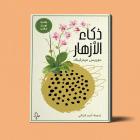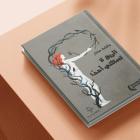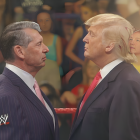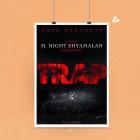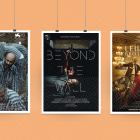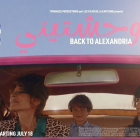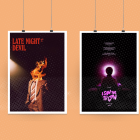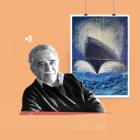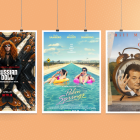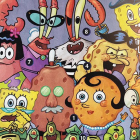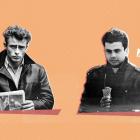فن
سفر التورط: كتابة الذات في مواجهة الهاوية
هناك نصوص لا تبحث عن قراء، بل عن شهود على هشاشة الإنسان..
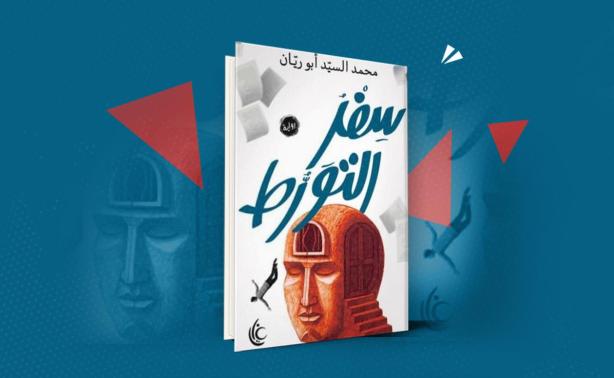 غلاف رواية «سِفر التورط» للكاتب محمد أبو ريان
غلاف رواية «سِفر التورط» للكاتب محمد أبو ريان
ثمة لحظة لا تكون فيها الحياة اختيارًا ولا مأزقًا، بل تورطًا خالصًا. لا ندخل العالم بمحض إرادتنا، ولا نمكث فيه كغرباء نتحكم في شروط إقامتنا. نحن مُلقَون في الوجود دون استعداد، دون عقد واضح، ودون ضمانات. يبدأ كل شيء قبل أن ننتبه، ونصير مشاركين في مسرح لم نكتب نصه، لكننا نُساق إلى أدواره، ونتحمل تبعاته. التورط هنا ليس خطأً أو قرارًا، بل هو المادة الخام للكينونة: أن توجد يعني أنك تورطت.
في هذا السياق الوجودي، لا يعود السؤال هو: «كيف نعيش؟»، بل: «كيف نتحمل ما حدث؟»، «كيف نروي ما لم نختره؟»، «كيف نصوغ سرديتنا من داخل الحفرة؟». ومن هنا تنبع فرادة العمل الذي بين أيدينا.
فرادة «سفر التورط» لا تكمن في بنية روائية محكمة، أو أحداث متماسكة، أو شخصيات تُبنى بمهارة تقليدية. العمل لا يسعى إلى الامتثال لشروط النوع الروائي كما استقر في الوعي الجمالي، بل يخلخل تلك الشروط عبر اقتراح سردي آخر، أقرب إلى النص الذاتي الوجودي. نحن لا نقرأ رواية بالمعنى الكلاسيكي، بل ندخل تجربة مكثفة لذات تتأمل مسارها، وتحاول أن تكتب عن نفسها من موقع الارتطام لا من موقع الأرشفة.
«سفر التورط» هو كتابة ضد النسيان، وضد التزييف، وضد الحكي المستقر. نصّ يرفض الترتيب، ويغلب عليه التوتر الداخلي، كأنه يُكتب تحت قيد الشعور الطازج، لا بدافع البناء. وهنا تبرز أهميته: ليس لأنه يقدم «حكاية»، بل لأنه يصوغ شعورًا بالحياة من موقع الهشاشة المطلقة.
الخروج عن الشكل: رواية أم لا رواية؟
ما يُقدَّم تحت عنوان رواية هنا ليس خضوعًا للنوع بقدر ما هو – في ظني – استعارة تصنيفية اضطرارية. «سفر التورط» لا ينتمي إلى الرواية من باب البنية، بل من باب المسافة؛ المسافة بين الذات وما جرى لها. لا حبكة تُبنى، ولا شخصيات تتكامل، ولا سرد يتصاعد، بل فصول متشظية، مقاطع يومية، رسائل نفسية، تأملات خام، وأحيانًا شذرات قاسية كأنها كُتبت على جدار زنزانة.
الرواية هنا ليست بناءً بل حُطام. ليست إنتاجًا للمعنى، بل تفكيكًا مستمرًا له، ونقضًا لليقين. وهذا التفلت من الشكل ليس عيبًا، بل هو ما يمنح العمل صدقه ومهابته: كأن الشكل نفسه لا يحتمل ما تحاول الذات قوله، فينكسر أمامه، أو يتشقق ليمنحه ممرًا.
الذات في مجابهة انكشافها
ليست الذات في «سفر التورط» مجرد حضور مركزي كما جرت العادة في السرد الذاتي، بل هي مساحة مُمزّقة، تقف أمام نفسها كمن ينظر إلى مرآة لا تعكس، بل تُشهِّر. لا تدور الرواية حول صراع بين «أنا» وأخرى، بل حول مواجهة عارية بين الذات وظلالها، حيث لا تعكس المرآة صورة، بل تُشهِّر وجودًا منخورًا.
الكتابة هنا لا تأتي فعلًا لاحقًا للتجربة، بل هي جزء من نسيجها الداخلي، كتقطيع متتالٍ في جسد المعنى. ليست الرواية «تسجيلًا» للحظات، بل «انكشافًا» لها، حتى يصير البطل عالقًا بين حاجته إلى التعبير ورفض اللغة أن تحتمله. وهنا يتجلى التورط لا كفعل، بل كحالة: حالة من انعدام القدرة على التمثيل، وانعدام البديل عن المحاولة.
الرجل يكتب لأنه لا يستطيع ألا يفعل. وحين يعجز، لا يعني ذلك أنه توقف عن الكتابة، بل عن كونه نفسه. لذا، لا يُبنى التوتر في النص على ما سيحدث، بل على ما لن يُقال. ما يظل عالقًا في الحنجرة. ما يتعذّر قوله لأنه فادح. من هنا، يتحول الصراع من مجرد حبسة كتابة إلى اختناق وجودي. كأن الذات لا تكتب لتحيا، بل تحيا لأنها ما تزال عاجزة عن قول كل شيء.
تفكيك النفس عبر هندسة السرد
لا تسير الرواية على خط سردي تقليدي، ولا تتوخى تتبع حدث خارجي أو تطور درامي. بل توزّع التجربة على ثلاث طبقات سردية في كل فصل، تُشبه إلى حد بعيد طريقة عمل النفس: موسيقى شعورية تمهّد للدخول، ثم غوص لاواعي في الهامش، وأخيرًا محاولة لملامسة العالم في المتن.
تبدأ كل وحدة سردية بما يشبه «تأهبًا عاطفيًا»، موسيقى أو نغمة افتتاحية، تمنح النص طيفًا شعوريًا يسبق أي مضمون. يليها الهامش، حيث لا وجود لبطل يتكلم، بل صوت يتداعى، يتشظى، يتكلم عن البطل ومن داخله في آن. ثم يأتي المتن كمساحة العالم الخارجي، لكنه لا يُغلق شيئًا، لا يحسم، لا ينقذ.
هذا الترتيب لا يتوخى التجميل، بل يعكس طبيعة المأزق ذاته: لا وجود لوعي صافٍ، ولا لحدث نقي. كل ما هنالك موجات متراكبة من الحضور، من الشعور، من الرغبة في القبض على شيء لا يتجسد. هكذا، تصير الكتابة نفسها بناءً للنفس كما هي تفكيك لها، ويصبح الشكل جزءًا من المضمون، أو امتدادًا له.
لا شيء في الرواية يُروى كي يُفهم، بل كي يُختبر. وهذه هي تقنية التورط في أوضح تجلياتها: القارئ لا يقف خارج التجربة، بل يُدفع داخلها، يُحاصر بانعدام السرد الواضح، وانفتاح العبارة، وتصدع البناء، ليعيش ذات التمزق الذي يعيشه البطل.
اللغة العالية كاختيار فني مقصود
الرواية – أو النص التأملي الوجودي – لا تخاطب القارئ العام الذي يبحث عن حبكة مشوقة أو شخصيات قابلة للتقمص، بل تتوجه إلى قارئ يريد أن يتورط بدوره، في لغة الذات، في دهاليز المعنى، وفي طبقات التأمل. وبالتالي، فاللغة المكثفة، الشعرية، الممعنة في الذاتية، ليست عيبًا، بل هي جزء من بنية النص ومزاجه، وهي ما يمنحه خصوصيته.
علو اللغة هنا مرآة لحالة البطل الذهنية والروحية. هو لا يعيش «الحدث» بل يغرق في «التأمل فيه»، واللغة تعكس هذا الغرق. بل يمكن القول إن الرواية ليست عمّا يحدث، بل عن كيف يُحس الكاتب بما لا يحدث، وكيف يدوّن استعصاء الفعل.
لكن من جهة أخرى، هذا العلو اللغوي قد يُشكل عائقًا حقيقيًا أمام التلقي. القارئ غير المعتاد على هذا النوع من الكتابة قد يشعر بالتيه، أو أن النص يُقصيه، لا يضمه. وهنا تنشأ إشكالية: هل على النص أن يُراعي أفق توقع المتلقي؟ أم أن عليه أن يفرض لغته ومزاجه الخاص؟
في حالة «سفر التورط»، قد يكون الوصف الأدق أن النص لا يعزل القارئ بقدر ما يشترط عليه أن يُعيد تموضعه، أن يقرأ ليس بعينه فقط، بل بوجدانه وإرهافه، تمامًا كما تُقرأ اليوميات الداخلية أو النصوص الصوفية أو الفلسفية التي لا تتوسل إرضاء القارئ بل تدعوه إلى مقامها.
الذات الكاتبة: من أين يُكتب هذا النص؟
ثمة كتابة تأتي من فوق، تنظّر وتنظر من علٍ. وكتابة تأتي من تحت، من باطن الجرح، من هامش الداخل. «سفر التورط» ينتمي تمامًا إلى الثانية. الصوت هنا ليس بطوليًا ولا نرجسيًا، بل مشوشًا، منهكًا، لا يطلب البطولة بل يطلب النجاة. الذات الكاتبة لا تستعرض حياتها، بل تحاول لملمة ما يمكن لملمته منها.
الكاتب لا يتكلم ليقول: «انظروا كم عانيت»، بل ليقول: «ها أنا أتكلم رغم العطب». وهذا الوعي بموقع الكلام – كلام من داخل الاختبار، لا خارجه – هو ما يعطي النص نبرة الصدق المر، دون أن يقع في فخ التشفّي أو البكائيات. لا يطلب من القارئ مواساة، بل يصارحه بالهشاشة، كأن بينهما عقدًا خفيًا: أن تكون إنسانًا يعني أنك مهدد بالتورط.
الألم في النص: بنية لا موضوع
الألم هنا ليس حادثًا ولا تفصيلًا، بل هو العمود الفقري للنص. الألم ليس ما يُكتب عنه، بل هو ما يُكتب به. لا يوجد مسافة بين الذات وما تؤرخ له. الكتابة تجري على الجرح لا عنه. وربما لهذا السبب، لا يظهر الألم في شكل نواحٍ أو توصيفات، بل في شكل أسلوب: التقطيع، الصمت، القفز من فكرة إلى أخرى، العبث بتسلسل الزمن. وكأن البنية نفسها مصابة.
هذا النوع من الكتابة لا يسعى إلى تمثيل الألم بل إلى محاكاته، إلى تقديم تجربة لا تُروى بل تُعاش. فالقارئ لا يعرف «ما الذي حدث» بقدر ما يشعر بـ«كيف كان وقعه». الألم هنا لا يُقدَّم كذكرى بل كخبرة حاضرة، تشتغل على اللغة وتفتتها كما تفتّتت الذات.
هل الكتابة شفاء؟
الأسئلة التي يطرحها النص أعمق من أن تُجاب، وأصدق من أن تُترك بلا أثر. هل الكتابة هنا شفاء؟ ربما، لكنها شفاء غير مضمون، شفاء هش. ليست الكتابة هنا مشروعًا علاجيًا بقدر ما هي محاولة للصمود أمام الذوبان. ما يُكتب لا يعيد ما ضاع، ولا يغير ما جرى، لكنه يخلق مسافة: بين الذات وما ينهشها، بين الصمت والكلام، بين العطب والصياغة.
ربما كل كتابة صادقة هي بهذه المثابة: لا تشفي تمامًا، لكنها تُبقينا واقفين. تتيح لنا أن نُبقي الجرح مكشوفًا كي لا يتحول إلى ندبة صامتة. وفي هذا المعنى، تكون «سفر التورط» شهادة لا على ما جرى فقط، بل على ما يمكن أن تفعله اللغة حين تضيق الحياة.
خاتمة: التورط كشرط للوجود، والكتابة كوثيقة هشاشة
نعود في الختام إلى الكلمة التي منحت النص عنوانه: التورط. ليس التورط هنا عيبًا أو ذنبًا، بل هو الجوهر الإنساني. أن توجد يعني أنك متورط: في الجسد، في الزمن، في العائلة، في الذاكرة، في الخوف، في الحاجة إلى الحب، وفي فداحة الفقد. لا أحد يخرج من التورط سالمًا، لكن بعضنا يملك شجاعة النظر في عينيه.